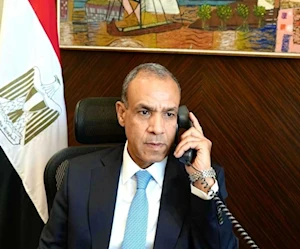صمت القوانين الدولية "حين تُقاوم الأرض دفاعاً عن السيادة اللبنانية"
التحدّي لا يكمن في شرعية الردع، بل في من يتحمّل مسؤوليته، فهل يمكن للدولة اللبنانية أن تُسلّم هذا الردع للجيش اللبناني؟ وهل سيسمح لها المجتمع الدولي بامتلاك منظومات دفاع جوي تُرهب المعتدي؟
-

الاعتداءات الإٍسرائيلية على لبنان (أرشيف).
في خاصرة الشرق العربي، يتكئ لبنان على إرثٍ حضاري يمتد آلاف السنين. وطنٌ متنوع الطوائف، ثابت الحدود منذ إعلان "دولة لبنان الكبير" عام 1920، لكنه ظل عرضة للطعن من خاصرته الجنوبية منذ تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ففي 31 تشرين الأول عام 1948، ارتكب هذا الكيان أولى مجازره ضد لبنان، حين اجتاح بلدة حولا ونفّذ مذبحة بشعة راح ضحيتها أكثر من ثمانين مواطناً أعزل.
هذه المجزرة كانت الشرارة التي قادت إلى اشتباك مباشر مع الجيش اللبناني، تُوّج لاحقاً بـ "اتفاق هدنة 1949" برعاية الأمم المتحدة، بهدف وقف الأعمال العدائية وضبط الحدود، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام سيادة الدول.
لكن الهدنة ما لبثت أن تحولت إلى حبر على ورق. إذ كرر الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، ونفّذ مجازر تروي فصولاً دامية من تاريخ لبنان، أبرزها:
مجزرة حولا 1948 قتل جماعي لمدنيين لبنانيين على يد الاحتلال، مجزرة العرقوب 1969، قصف عشوائي أدى إلى مقتل وتهجير سكان جنوب لبنان، مجزرة صبرا وشاتيلا 1982 مجزرة مروعة بحق اللاجئين الفلسطينيين والسكان المحليين، مجزرة الغجر 1985اجتياح واعتداء على قرية لبنانية حدودية، محزرة قانا الأولى 1996 قصف مقر تابع للأمم المتحدة أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني من الأطفال و النساء، مجزرة المنصوري 1996استهداف سيارة إسعاف تقل أطفالاً ونساء، مجزرة قانا الثانية 2006 قصف منازل المدنيين وسط تجاهل النداءات الدولية لإيقاف هذه المجازر، التي صنّفتها مؤسسات دولية وحقوقية كمخالفات صارخة لـاتفاقيات جنيف لعام 1949، تقوّض مفاعيل هدنة 1949، بل تحوّلها إلى ذريعة فارغة أمام مشهد القتل المنهجي.
فهل يُعقل أن تُمارَس مثل هذه الجرائم في ظل اتفاقية سارية رسمياً؟
ما بين الغارات الجوية والتوغلات البرية والانتهاكات الحدودية، تحوّلت الهدنة إلى جثة معلّقة على جدار الأمم. الاحتلال الإسرائيلي تجاوز حدود الاتفاق مراراً عبر تنفيذه أعمالاً عدوانية عسكرية مستمرة، استهداف للمدنيين والبنى التحتية، رفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي مثل القرار 1701.
هذه الانتهاكات لم تُقابل بعقوبات دولية أو تدابير رادعة، ما أدى إلى:
- تصاعد التوترات على الحدود.
- تمدّد المقاومة اللبنانية كرد فعل شعبي على غياب الحماية الدولية.
- تآكل الثقة بمؤسسات الأمم المتحدة كضامن للسلام.
في العام 1974، أدرك الإمام موسى الصدر هذا الواقع، فأسس المقاومة اللبنانية الشعبية لحماية الجنوب من العدوان المستمر. هذا الفعل، الذي انطلق من الأرض لا من القاعات الرسمية، يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تشرّع الدفاع عن النفس أمام العدوان.
لكن التحدّي لا يكمن في شرعية الردع، بل في من يتحمّل مسؤوليته مستقبلاً، فهل يمكن للدولة اللبنانية أن تُسلّم هذا الردع للجيش الوطني اللبناني؟ وهل سيسمح لها المجتمع الدولي بامتلاك منظومات دفاع جوي تُرهب المعتدي وتطمئن المواطن؟
أم سيبقى الطلب الوحيد هو عدم امتلاك لبنان اي قوة لمواجهة أي عدوان على سيادته..
لذلك، لبنان لا يطلب أكثر من حقه. لا يبتغي سوى كرامة تُصان وحدود تُحترم وشعب يُحمى. الصراع يجب ألا يُختزل في بندقية، بل في إرادة دولة تُعيد تشكيل نفسها، تستنهض جيشها، وتفرض احترام سيادتها على من اعتاد انتهاكها.