رواية "هوارية": الذات المنبوذة عندما تتحول إلى وحش
اعتمدت الكاتبة إنعام بيوض في عملها على سبر نفسيّة المهمّشين... أولئك الذّين ينفيهم المجتمع نحو الموت الرمزيّ، وينفيهم الأهل نحو ألقاب جديدة، الباحثون عن القيمة حتّى لو كلّفهم ذلك التّحول إلى وحوش.
-
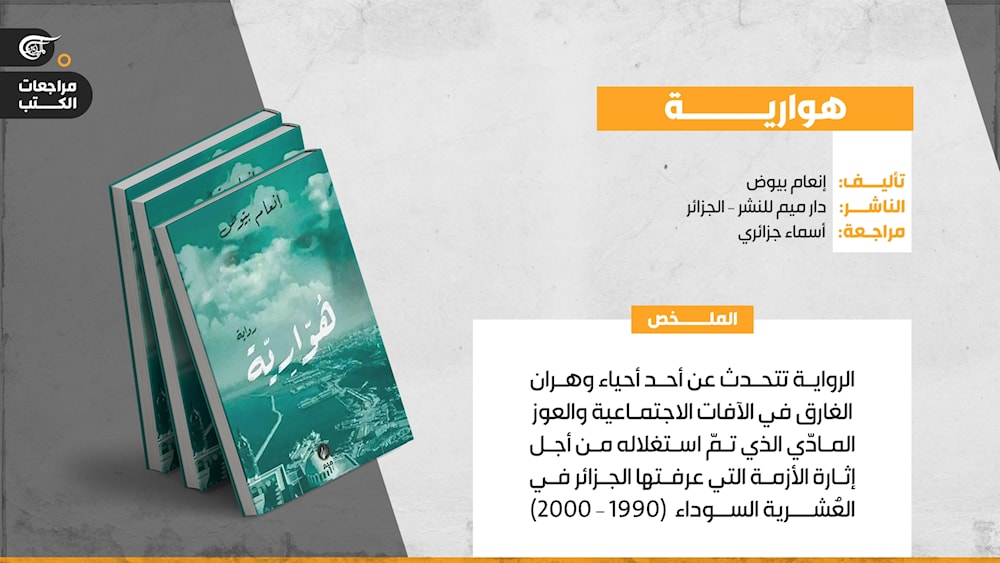
رواية "هوارية" لإنعام بيوض
اهتمّ الإنسان بالاحترام، بالشّعور بالقبول من الآخرين، وبأنّه "ينتمي"، لهذا اخترع لنفسه ألقاباً ومكانة وأشجار عائلة، وسعى طيلة حياته لتحقيقها أو الحفاظ عليها، ثم أوجد لأجل الانتساب إليها معاييره الخاصّة. الإنسان الذي يفقدُ شعوره بالانتماء يُلقى خارج الوجُود ويتصرّف على أساس ذلك، حيث لا تعود ثمّة أهمية لأخلاق السّادة، فحينما يرفضُه الآخر، أو يعزّز فيه الإحساس بالنبذ يسيطر عليه "مفهوم الظّل" الذي تحدّث عنه كارل يانغ.
الجميع أفضل منه، وعليه أن يُحاول تعويض ذلك بالانغماسِ في مُضاعفة الأفعال أو الأفكار التي يرفضونها أو مضاعفة إصلاح الوجُود الخارجيّ لهذه الذات، وسواء كان منغمساً في إثبات صحّة ما ينبذُونه أو إثبات عكس ذلك، فإنّه فعلياً قد سلّم نفسه إلى سطوة الشّعور بالنّقص واللّهاث الذي تكوّن من جراء الكبت المتواصل لمشاعر تألفها النّفوس. الشّخصية التي تشعر بالنّقص شخصية عاجزة عن إظهار مشاعرها بسبب الخوف أو العِقاب أو الخجل من نظرة الآخرين إليها، لذا تتبنى الطرق الملتوية لإفراغ كبتها. هذا ما حرّكه عمل "هواريّة"، "النّبذ"، ليس فقط داخل العمل الأدبيّ، بل وخارجه أيضاً، امتد نحو الواقع، فالشّخصيات المنبوذة أدبياً لم يتفهّمها -كما هو متوقع -الواقع، ورماها – الرواية -المجتمع بعيداً وكأنّه يتخلّص من شيء مقزّز.
إن الشّخصية المنبوذة لا يمكنُها إثبات وجودها، لأنها تعيشُ الإنكار الوجوديّ، شخصيّة لا يمكن إنقاذها لأنّ الآخر صاغها باللاوجود، ومن ثمّ لا يمكن أن تُنقذ شيئاً غير موجود من الأساس، إنّك تعذّبه على خجلك منه، والشيء النّافع لهذه الشّخصيات هو الاعتراف بوجُودها حتّى تستعيد ذاتها الوجودية، ومن ثمّ تتمّ محاورتها. هواريّة المحرومة من حنان أمها المقصيّة من العائلة "ها" التغريب "هاذيك" التّحقير، أم تمنت لو كانت طفلتها صبياً، وحينما عجزت أمام الواقع سمّتها استلهاماً من اسم أخيها الهواري، شخصيّة مرفوضة تماماً منذ ولادتها، وعلى ضوئها ستسيل العديد من كفوفهم الموضوعة داخل كفّها، وتنبعثُ من أنفسهم قذارة العالم ورقتها وأسفها.
تبدأُ الرّواية رمزياً بالجملة الشّهيرة التّي يتنصّل بها الكلّ من الكلّ كأنّهم يغسلون أقلامهُم ممّا سيكتبُونه لاحقاً، الكاتب أيضاً يتخلّص منهم قبل أن يتركهم بين الأوراق: "إنّ أيّ تشابه في الأسماء والأماكن والأحداث المذكورة في هذه الرّواية ليس سوى محض مصادفة"، وفعلياً بنظر "هوارية" نحو سقف مستشفى الأمراض النفسيّة، ثمّ تنتهي بالسّمكة ذات الجناحين التّي طارت مع بطاقتها من يد هبة العائدة نحو المكان الذي ينتمي إليها بعد أن كلّفها ذلك خسارة كل الذين تنتمي إليهم، وبين هاء هوارية وهاء هبة ستولد هاءات كثيرة لا نعلمُ هل هي نهاية تأوّه أم بداية ضحكة هيستيرية بما يقارب 224 صفحة.
تدور الأحداث في حي "لكميل" بمدينة وهران، في الحقبة التي شهدت فيها الجزائر تزعزعاً خطيراً في الأمن، والتي يُطلق عليها بالعشريّة السّوداء، حيث ساد الفساد في كلّ الأرجاء، وانفلتت الشّرور من القُصور لتستقر في الأحياء الشّعبية، ثم انفلتت ذات الشّرور من الأحياء الشعبيّة لتتلولب على الكراسي المذهّبة. تشبعت الشّخصيات بالخوف والكره واليأس، والتّمادي، تشبعت بالتّطرف في كلّ شيء، اختفت الوسطيّة، وانهارت كما في كلّ استبداد، كلّ الأطر الأخلاقيّة، وما أحداث العمل الروائيّ إلا بضعاً من تلك الهوّة السّحيقة التّي وقف عليها جيل ٌكامل في الجزائر.
قد يرى البعض النّص جريئاً، وآخرون يرونه منحطاً، لكنّه العمل الذي كان ذاته، الكاتبة التي اعتبرت أنّه نص مسكوت عنه فقامت بتوجيهِ الأنظار نحو الأبراج المسقُوفة بالمثالية، المجتمع المحصّن بالنفاق، الزوج المتاجر بالأعراض والدّين، المنخرط في صفّ الأمن والناشط داخل جماعة إرهابية، التّجار الذين يضاعفون أموالهم في الأزمات، المثقفون العالقون بين وسائد الستان، المناضلون اليساريون الملتحفون بخطابات إنشائيّة، الحياة الصّوفية التّي يعاد إحياؤها لأغراض سياسية، اللّحى المصنوعة من جزّ الرؤوس، كلّ هذا العنف الرمزي والفعليّ بقي ككدمة زرقاء على ذاكرة البلاد. نعم، إنه الاستبداد الذي يفسد أخلاق الشّعوب فيجعل من متدينيهم منافقين، ومن مثقفيهم جبناء ومتسلقين، ومن حماة أمنهم قتلة وأذلاء ومرتشين، نعم إنه الاستبداد الذي يرفع في أي بلد من قيمة الخونة والمارقين وينفي المخلصين الصادقين.
فهل تحتملُ هذه الأجواء والشّخوص المنبُوذة والمطرُودة من الفضيلة نفاق اللّغة؟
دائماً ما نُرجعُ بعض الفضل إلى اللّغة التّي تُستخدم في أيّ عمل أدبيّ في أخذ الكتاب أو تركه جانباً، فلا يمكنُ للغة الجيّدة الخالية من الفكرة أن تمضي قدماً، كما لا يمكن للفكرة الجيّدة الخالية من لغة تبلورها أن تُبقي بنا إلى جواره، وفي "هوارية" كانت اللّغة مباشرة بحكاياتها المألوفة (مع بعض التّحفظ على الهفوات التّي طرأت داخل أحداثها)، وعلى بساطتها هذهِ وهروبها من التّكلف في تشكيل الجُمل أو الشّخصيات، أو السّرد، استطاعت أن تحرّر الأحداث من الخجل الاجتماعيّ، أو الخجل الأدبيّ، أو عقدة الصّمت، فحينما تكون شخصية ما صامتة تتحدّث في صمتها ذاك إلى المتلقي بالطريقة التي تشعرهُ أنّه غير موجود، أنّه ليس المُراقب.
رواية كتبت انطلاقاً من التّفاصيل اليوميّة لأشخاص مرفُوضين يطرحون ذواتهم للوجُود، متحدّين بذلك كلّ من عاشوا يشطبُون وجودهم سواء على الصّعيد الواقعيّ أو المتخيّل، أدوار مألوفة لا تحمل ابتكاراً في صياغتِها، ليكتشف القارئ الفرق القائِم دائماً بين الواقع مثلما هو وبين الواقع مثلما يعيش أو يعاش في الدّاخل، فجيل دولوز الذّي يقُول إن كلّ رواية هي سيرة، سيرة طُفولة العالم وليست سيرة طفُولة الكاتب أو القارئ، يعدّ الإنسان النّكرة غير المعرف على المستوى العام هو ما يجب أن يُكتب عنه، أمّا الكاتب فمهمته هي الكتابة نيابة عن الآخر وليس "الإيغو" الشّخصي، وهو يتجاهل في ذلك مسألة في غاية البساطة، وهي أن أي كاتب هو نكرة بالنسبة إلى القارئ، وأن الخاصّ بالنسبة لنا هو العام بالنسبة إلى الآخر.
هذا ما تبنّته "إنعام بيوض" من أفكار الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز، واستنطقت بلغتها التي لا تفوتنا رقّتها في التّوصيف، والأسف والحزن في تشكيل المصائر، ويسيل منها الغضبُ كلهجة وهرانيّة، إنّهم نكرات وهران وهم يمثلّون نكرات المجتمع الجزائري ككلّ، والنكرات في أيّ مكان في العالم، فالشّخصيات حينما تغضب تكتب الكاتبة غضبها بلهجتها، ربّما تكُون هكذا قد ترجمت ذلك بكلّ مصداقيّة، اللّغة عاجزة أمام الحقيقة في مشهد ما، سيعجبُنا الغضب بالشّكل الذي لا تريده الشّخصيّة ذاتها. لكن، هل أعجبنا الغضب أو لغة الغضب؟
الغضب لا يحتاج للإعجاب هنا بدلاً من أن يكون حقيقيّاً، وحتى لا يكون كذلك ألحقته باللّهجة الوهرانيّة، وقد أصابت الكاتبة حينما اختارت ذلك، فالمُتلقي شعر بغضب هوّاري إلى الحدّ الذي أغضبت كلماته تلك المجتمع بأسره، لا يمكن لشخصيّات هادية وهواري وهوبل على سبيل المثال أن تمتلك لغة مُحترمة، إن ذلك نشاز سرديّ يستطيع أيّ قارئ الشعّور به، هم المنبوذون الذّين ألقت بهم الظرّوف داخل حي "لكميل" حيث يعم الفقر والخيانة والمخدرات والمومسات والجهل، ويطلق على أزقته "كلاه بوبي"، "طريق البايرات"، "زنقة الحلوف" ويعلق على باب ماخوره "حمام الصالحين"، لقد انعكس انعدام الأمن في العشريّة السّوداء على الأفراد بأبشع الصّور، فالشّعوب المقهورة تسُوء أخلاقها، يلاحقها البوليس بمسدساته والأرستقراطيون باشمئزازهم واحتقارهم، والمتشدّدون بسكاكينهم، هذا ما يفسّر اختيار الكاتبة لتلك الجُمل النابيّة تحديداً، إنها تمهّد لك عبر هذه الحيوات المنبوذة والأفق المنغلق، والبيوت المكبوتة والعنف المتسيّد والهشاشة المنفرطة، حتّى إذا ما انزلق لسان الشّخصية تتفهّم مدى ذوبان اللّباقة خلف لسان حادّ.
ماذا لو كانت الرّواية تُحاول مساعدة الشّخصيات بدل فكرة إلهائهم بالحكي؟
اعتمدت الكاتبة إنعام بيوض في عملها على سبر نفسيّة المهمّشين، المرفوضين، أولئك الذّين ينفيهم المجتمع نحو الموت الرمزيّ، وينفيهم الأهل نحو ألقاب جديدة، الباحثون عن القيمة حتّى لو كلّفهم ذلك التّحول إلى وحوش، شخصيات مُنهكة في عالم ينهارُ تحت أقدام الجزارين وأفرشة الحرير، حيث تختفي أنبل الأخلاق ويتبنّى العالم من حولهم ذلك التّدهور كنتيجة حتمية، الحبّ الذي لا يكتمل، الدرّاسة التّي لا تكتمل، الأخ الذّي لا يعُود، الزوّج الذي لا تستطيع رفضه، المثقّف الذي لا تستطيع أن تُصبحه، التقيّ الذي لا تستطيع أن تغسله، الابن الذي لا يستطيعُ أن يكون أملاً، شخصيات عاجزة عن تحقيق سعادتها، تائهة وربما هاربة، مطاردة تارة ومطرودة تارة أخرى، إنهّا تبحث عن القيمة في أيّ مكان، اعتراف الآخر بأهميتها في الوجود على علّتها، لذلك ادعت "هجيرة" أنهّا ذهبت إلى الحج، حتى تحصل على الاحترام، الطبيب الهاشمي الذّي يُطيل في سرد التاريخ أمام عشيقته هادية المنبهرة لتلك المعلومات ترضي غروره وتشعره بالأهميّة، هواري الذّي أطال لحيته ليكتسب مركزاً، أمّا "هواريّة" وهي الشّخصية التّي اختارت الكاتبة أن تكون عنواناً لعملها، لا لأنّها أهمّ ما في العمل، فكلّ ما وجد فيه كان على القدر ذاته من الأهميّة، فالمآسي كلّها بالقدر ذاته مهما اختلف وقعها، بل لأنّ كل الشّخصيات الأخرى ستنتهي عندها، لا يربطهم فقط حرف الهاء الذي يحملونهُ في بداية أسمائهم، بل مصائرهم أيضاً في حيّ "لكميل" الذي يعدّ مسرحاً للأحداث.
وربما سيلفت انتباهنا في البداية هذا الاختيار الأبجديّ للأسماء في العمل الروائيّ، لكن سُرعان ما سيتبدّد ذلك حالما تنتهي هواريّة إلى عرّافة، صوفية، روحانيّة. نتذكر الآن فكرة حسن الصباح مع أصدقائه في الحشّاشين، يأخذ أياديهم ثم يروي لهم ما سيحدثُ في حياتهم، تتقاطعُ هنا الفكرة، فهواريّة تقُوم بذلك أيضاً، صحيح أن كلّ العرّافات يقرأن الكفُوف لكن ليست كلّ العرافات روحانيات، فحرف الهاء هو من الحروف النّورانية عند الروحانيين، إنّه أضعف الحروف، حرف خفيف ورائع، ولكن ننتبهُ عند النّطق لأنه حرف خفيّ وبعيد المخرج، إن الحرف يشبه شخصياته، هوارية، هناء، هشام، الهاشمي، هبة، هاجر، هاني، هوبل، هالة، هبري.. إلخ.
وحتّى نستمع إليهم وجب أن يضعوا كفوفهم داخل كف هواريّة، شخصيات بلا أصوات، بل مُستنطقة من خلال قارئة كفّ، إننا أمام تائهين ومعذبين، بالكاد تلمح أرواحهم المهزُومة، أو يُسمع عن أسمائهم، وحين يختفُون، يختفُون إلى الأبد، حتّى على الألسن، يصرخون كلّ وطريقته، بالصّمت، بالثرثرة، بالمخدّرات، ببيع الأجساد، بإطلاق اللّحى، بالذهاب نحو بيت الله كذباً، شخصيات كثيراً ما ينتهي بها الأمر إلى رفض القيم والمعايير الاجتماعيّة والاغتراب عن الحياة الأسريّة وهذا ما سنكتشفه عند هدية وحتى هواريّة وهاني كمثال.
فما لا نجلبهُ إلى نور وعينا يظهرُ في حياتنا كمصير حسب عالم النفس التحليلي كارل يانغ، هنالك سيطرة لا شعوريّة يمارسها "الظلّ" في السّلوكيات التدميرية الذاتيّة التّي تواجهها الكثير من الشّخصيات ولا تستطيع السيطرة عليه، رغم درايتهم التامّة بأنّهم سيكونون أفضل عندما يتجنبون تلك الممارسات. المدمنون، المومسات، القتلة، تجار البشر، تجار الفضيلة، الرفقاء الأبطال، كلهم مدفوعون بظلالهم، والتّي تمثل الحرب الداخليّة الموجُودة داخلهم، في أوقات شديدة النّزاهة يعِدون أنفسهم بأنهم سوف يتخلون عن تلك الأفعال وينظفون حياتهم، وفي وقت يلي تلك الأوقات يتغلّب ظلّهم على الأنا الواعي، فيبحثون في حماس مُنقطع النظير عن عادتهم تلك.
إن الإنسان باعتقاد روبرت ستيفنسون ليس شخصاً واحداً، لكنه حقاً اثنان، لديه شخصيّة واعية ولديه ظلّ، كلّ منهما غالباً ما يقاتلُ من أجل التّفوق في ذهنه، وإذا ما تحدّثنا عن شخصيّات كهذه فالدّاعي لن يكون الحكي، ولا الأخلاق، ولا البطولة، إنّ الأهم في الرواية الاجتماعيّة كان دائماً يتمثّل في تقديم الخللِ لمساعدة الشّخصيات الغائبة داخل العالم المنبُوذ، وهذا هو أقلّ استحقاق.













