هندسة الجوع في رواية "الدار الكبيرة" لمحمد ديب
لم يكن يكتب "محمد ديب" ليستنجد أحداً، بل كان يكتب لينقذ الجزائري هويته المناضلة من بين هندسات الجوع التّي تمنعه من الثقة في مقدرته على تجاوز خوف الخسارة.
-
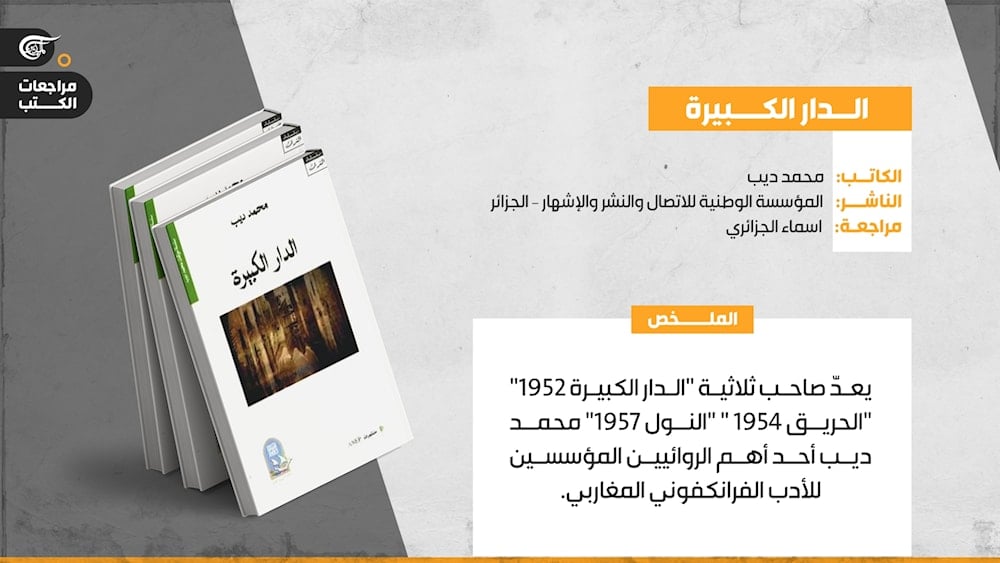
هندسة الجوع في رواية "الدار الكبيرة" لمحمد ديب
هل يستنجد محمد ديب أحداً وهو يكتب "الدار الكبيرة"؟ أم أنه يعلنُ عن نبوءة حرب التحرير؟
عانت الدول المغاربية من الاستعمار وكانت للجزائر حصتها الكبيرة من المعاناة. إذ كانت الحياة تنقصها الحياة برمّتها، فحرمت الشعوب من ضروريات العيش الحيوية كالغذاء الذي يعدّ محرك "البقاء"، فاكتسب الأكل وتناوله أهمية كبيرة إلى أن تلقّفه الفكر والأدب. صاغ محمد ديب من الحرمان صوت الجزائر المعذّب، ومن أنين المعذبين رسّخ نبوءة جاءت لتكمل ما عناه في ما كتبه، إنّه لم يكن يكتب ليستنجد أحداً، بل كان يكتب لينقذ الجزائري هويته المناضلة من بين هندسات الجوع التّي تمنعه من الثقة في مقدرته على تجاوز خوف الخسارة. يقول محمد ديب إنّه لطالما تعامل مع الوطن كمحام يرافع باستمرار باسم شعبه ووطنه، ذلك لما حمله من مسؤولية تجاه كل الذّين حرموا العيش الكريم فقط لأنّ استعماراً جائراً سلط عليهم.
ويعدّ صاحب ثلاثية "الدار الكبيرة 1952" "الحريق 1954 " "النول 1957" أحد أهم الروائيين المؤسسين للأدب الفرانكفوني المغاربي، إذ نقل مأساة الشعب بلغة فرنسية يفهمها الفرنسيون أنفسهم، فرسالته في عمله كانت موجهة كبندقية بطلقة واحدة تجاه ذلك العنف المجانيّ وتلك الوحشية المخجلة، حتى استكثروا عليه اسم "محمد" على أغلفة كتبه الأكثر مبيعاً. لقد استطاع وبخيط الاتنوغرافية الرفيع أن يمرّ داخل متاهة لينسج صورة "دار سبيطار" المعقدة والأليمة، قلعة البؤس هذه هي مسرح الجياع والمظلومين، فيدرك القارئ فوراً أنه أمام مجتمع مصغّر عن مأساة وطن كبير. إن تلك الدار مليئة بالنساء الأرامل الحزينات المشحونات بالغضب، والشيوخ المرضى العاجزين عن الحركة والأطفال الهزيلين، والرجال المطاردين. إنّه فضاء انفعالي وعنيف يصوّره لنا الكاتب بغية أن نعيش مع "عمر" ما يحيط به، وربما يخطر في بال القارئ أن الشخصيات هذه ستكون مشكلة في مواجهة بؤسهم، هم شبه مغيبين عن لبّ القصة، ومعدمين في الحكاية المسترسلة، لا أثر لوجودهم في معركة الجوع، لكن ما إن دوّت صفارة الإنذار معلنة الحرب حتى اجتمع الناس في ساحة تلمسان، فيتحوّل هؤلاء المنسيون حتى في السرد إلى جزء لا يتجزأ في القصة الكبرى.
فهل كان بطل "الدار الكبيرة" الطفل عمر أم الجوع؟
تبدأ رواية الدار الكبيرة بـ "أعطيني قطعة خبز"، يبدأ المعنى بالطعام، يبدأ بمقدرة تحويل هذا الطعام إلى سلاح يمكن أن يستخدم لأخذ منك حقك في المقاومة، يبدأ بخطفك من لذتك، أو خطف لذتك منك ولا ينتهي إلاّ إذا تحوّل الجوع إلى ظلّك. محاصرة الإرادة بالأمعاء جرّدت الكثير من الشجعان من أسلحتهم، فترك الحق مقابل الحصول على الأكل، وهكذا هزائم ليست هزائم بالمعنى الحقيقي لأن انتصار الآخر ليس انتصاراً بالمعنى الأصيل، بل هو هزيمة أمام تاريخ الإنسانية، وشرعنة الأسلحة أيّاً كانت في الحروب لأجل كسبها لا تمنعها من أن تلطخ بالعار طيلة تاريخها، وها هي أجيال كثيرة تردد ذلك العار لأنّ ثمّة ضحايا ورّطوا في موت لم يكونوا طرفاً فيه، وسلطت عليهم بشاعة أطاحت بالذين سلطوها عليهم. وإذا حاولنا البحث عن البطولة في حروب الجوع، فإن الأمر سيتطلب منّا فهم ماهيّة البطولة، هل في مجابهته أو الاستسلام إليه، فتظهر معاناة الطفل عمر من مشكلتين: الأولى بيولوجية وهي متعلقة بمشكلة الجوع، والثانية فكرية متعلقة بوعي العالم من حوله، إنه يخوض داخل وجوده حربه البريئة حتى يعيد صياغة "دار سبيطار" بالشكل الذي لا تعود فيه منزلاً للمعاناة البيولوجية بل قلعة لشرارة التفكير.
فهل تمكّن الجوع من إخضاع" الدار الكبيرة" لهوية المستعمر؟
يسير الجوع في أركان الدار الكبيرة كما تسير قدما عمر النحيلتان، ويتحرك كما تتحرك كتفاه الخفيفتان، في كل مكان يمكنك أن ترى طيفه إلى أن ينتابك شعور بأنه ليس حالة بيولوجية فحسب بل أصبح كياناً مألوفاً، أصبح صاحب الدار وبطل الرواية سويّة. ويصف الكاتب أمراً كهذا بطريقة مأساوية تنهش عاطفتك: وكان الجوع الرهيب لا يتركه في يوم من الأيام، فليس في البيت شيء يأكله، وكان يبلغ من فرط الجوع في بعض الأحيان أن لعابه ينحلب فيه زبد، كان همه الوحيد إذاً أن يعيش، أن لا يموت، وقد اعتاد أن لا يشبع أبداً، في تلك الأحيان، ألف الجوع وألفه الجوع، حتى أصبح يعامله معاملة الصديق للصديق، فلا كلفة بينهما، لقد قامت علاقتهما على أساس من اللباقة المتبادلة الخفية اللطيفة التي لا يستطيع إلا التعارف الواسع أن يولدها بين أناس يسيء بعضهم الظن في بعضهم الآخر أول الأمر، ثم يشعرون أنهم قد خلقوا بعضهم لبعض. وبفضل هذا التفاهم، قلب عمر أنواع اللامبالاة التي تنشأ عن الخوف والكسل، قلبها إلى حب، فلو خطر بباله أن يفصح عما في أعماق نفسه لقال ولا شك هذا الكلام: إيه أيتها الأم الحبيبة، أيها الجوع في المساء، وقد غرقت نفسه وعيناه في تحية واسعة بينما الجوع له يبتسم ويقترب منه"، هو تحويل شجي للمعاناة إلى ألفة، حيث تتخطى معناها المقيت للاستسلام، وما تلك الأسوار التّي تعيش داخلها عوائل كثيرة فقرت إلا مسرحاً لهذا التوحش، حيث يظهر الجوع متعدد الصفات على الناس، فمرة يأخذ شكل العنف اللفظي، ومرة العنف الجسدي، ومرات عنف بيولوجي، وفي لغته الشفافة والعاطفية المحمولة بالكثير من المأساة يروي لنا الكاتب كيف يمكن أن يهندس هذا الجوع العالم في قصبة تلمسان حيث دارت أحداث الرواية، ليخرج من بين فكيه المتخمين بالغضب مثل الأم "عيني" التّي حوّلها الجوع إلى امرأة قاسية، لقد جرّدها من عاطفتها.
ليس هنالك وقت للتأمل في الأحزان لأن المأساة تمنع حدوث المواساة، هنالك أشخاص يجب إطعامهم، زوج توفي، ابن توفي، ثلاثة أولاد، وأمّ طريحة الفراش تخلى عنها أولادها، إنها غاضبة من كل الأذية التّي لحقت بمن تحبهم إذ إن أذيتهم آذتها فحوّلتها إلى جدار من تلك الجدران في "الدار الكبيرة". " هذا كل ما تركه لنا أبوك، ترك لنا البؤس وغيّب وجهه في التراب وسقطت عليّ جميع أنواع الشقاء". إذاً، هي في عراك دائم مع الجوع لا لتهزمه لكن لتأخذ منه قطعة خبز، إنها تتحايل عليه حتى يعيش أحبّتها، تضع قدر الماء يغلي، نعم هنالك أكل يطهى، عليكم فقط أن تنتظروه، أن تقاوموا نومكم، يغط صغارها في النوم متأملين القدر على النار، هنالك أكل يطهى، هنالك أكل يطهى حتى حينما تكون القدور فارغة فتدوس قدماها أكثر على عجلة الخياطة، وهنا نرى الصراع على الوجود، فنفاد الطعام يعني الموت، ومحاربة الجوع تعني محاربة الاستعمار ذاته، استعادة الخبز تعني استعادة الجزائر من فرنسيتهم، الأكل يعني التفكير، يعني الشروع في المعرفة، والشروع في فهم الهوية، وإذا ما لم يأت هذا بطريقة سلسلة فعلى الآخر أن يعدّل سير الحكاية، فالأستاذ حسن يعني التدخل العاجل لاستعادة المعرفة من التحريف، إن سؤالاً واحداً وجّهه إلى الأطفال داخل الصفّ كان كفيلاً بمعرفة أين وصلت عجلات اختطافهم "من منكم يعلم معنى الوطن؟" سأل، الأطفال هم مستقبل النضال فإلى أيّ صف ستكون بنادقهم إذا لم يفهموا هويتهم، إذا لم يعرفوا وطنهم؟
يجيب طفل: الوطن هو أمنا فرنسا، لكن كيف تكون تلك البلاد البعيدة أمه؟ يعترض عمر في قراراته عن جواب كهذا، يعترض لأنّ الكاتب يقدّم لنا من خلاله الوعي المتنامي داخل الأزقة، المتنامي من القلق، من التساؤل، من الرفض، عدم مقدرته على الإجابة لا تعني أنه لا يعرف أن فرنسا ليست وطنه، فالمكان "المدرسة" حيز فرنسي يصعب فيه الاعتراف بكل ما يجول في خاطرك، لقد خطف الاستعمار الحرية، صحيح أنه هنا داخل هذه الأسوار المغصوبة لكنه بقي ينتمي للجزائر، حتى الأستاذ حسن الذّي يعمل داخل هذه الأسوار يعلم أنها أسوار تخطف الأطفال من هويتهم، لهذا قال مصححاً:" الوطن هو أرض الأجداد، وحين يأتي من خارج الوطن أناس أجانب يدعون أنهم السادة فإن الوطن يكون في خطر، هؤلاء الأجانب أعداء يجب على جميع الأهالي أن يدافعوا عن الوطن، أن يقدموا حياتهم ثمن ذلك" ص20، إنّه يعيدُ هؤلاء الأطفال إلى صدور أمهاتهم ليصنع لغد قريب أبطالاً من صلبه يخرجون من جوعهم نحو جوع أكبر، الجوع إلى الحريّة " ليس صحيحاً ما يقال لكم من أن فرنسا هي وطنكم" ص21 يأتي جوابه تكميلاً لسحب تلك الشفاه من الرضّاعات الاستعمارية حتى لا تكون حصة الأسد في هذه الأجيال لمن سيخذلون العمل النضالي، من يفضلون الاستقرار المذل على الاستقلال الملطخ بالدماء، من ينتمون إلى الراحة المتوترة على الراحة المجهولة.
يرتب محمد ديب ذلك بكل حرص ويصوّر لنا "عمر" الذي تنمو في داخله فكرة النضال من دون أن يرمي به أحد نحو المعركة، تتشكل لديه الحرية من تلقاء العنف الذي يمارس عليهم، فيفتح فمه لمعرفته أنّ الجزائري في كل مكان حتى حينما تراه جزائرياً فرنسياً سيدهشك من أنّ ذلك الوعاء نضال أيضاً لأجل جزائر مستقلة، فكل مفجري ثورة التحرير شباب تخرجوا من مدرسة فرنسا التي كانت ترضعهم حليبها الاستعماري، عمر يشبه تماماً أولئك الذين سيأتون في الفاتح من نوفمبر ليطلقوا شرارة التحرير، إنه "حميد سراج" الذي يسكن الدّار نفسها ويقود تجمعات سرية يحضرها الفلاحون لتوعيتهم بضرورة النضال، على المناضل أن يكون شجاعاً لكن أن لا يفقد رحمته أيضاً، وعمر هو هذا التشكل الأنيق لروح النضال الذي صاغة محمد ديب بكل نبل،" لن أسمح لأحد أن يدوس على قدمي، ولو كانت أمي التي أرضعتني" وكان يدافع عن أولئك الذين يستبد بهم كبار التلاميذ، فهو طفل شجاع مقدام رحيم ودود نجد ذلك يتجلى في مساعدته لجدته المريضة فتناديه" أنت وحدك ترحمني ثم تسأله أن يجيء إلى قربها"، هذا الصوت الطفولي والروح الحرة يمنحان الفضاء غراء تتماسك فيه الحكاية حتى لتظن أنه حوّل الجوع إلى قصة، حوّل الجوع إلى بندقية، حوّل الجوع إلى حريّة حوّل الجوع إلى 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1954.













