فيصل درّاج يكتب سيرة المغلوبين
في رحلة الشاحنة نحو الشمال وتوقّفها أمام استراحة على الطريق، ستلفت انتباه الطفل صورتان، سيعرف لاحقاً أنّ الأولى للمجاهد الفلسطيني عبد القادر الحسيني، والثانية للزعيم السوفياتي جوزف ستالين.
-
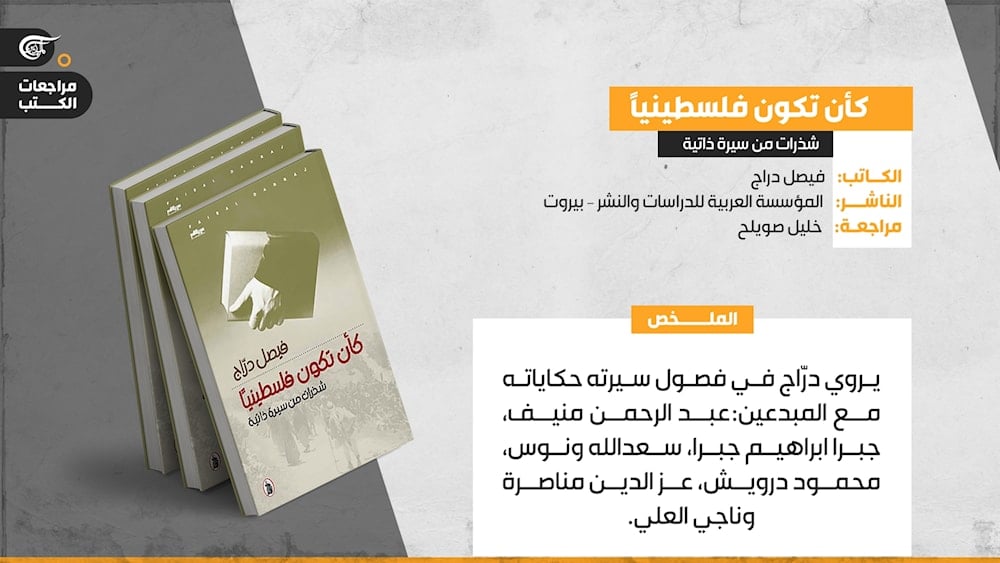
"كأن تكون فلسطينياً" لخليل صويلح
يستدعي فيصل درّاج في كتابه "كأن تكون فلسطينياً: شذرات من سيرة ذاتية" الصادر عن "المؤسسة العربية للدراسات والنشر" سيرة المغلوبين، أو سيرة الجموع، فهو ينأى بسيرته الشخصية نحو الظلّ لمصلحة شخصيات تركت أثراً في حياته، وتالياً نحن إزاء سيرة معرفيّة في المقام الأول. المغلوب هنا هو الفلسطيني اللاجئ، ذلك الذي اقتُلع من جذوره نحو مكان مؤقت وإذا بذكريات المكان الأول تمنحه بعض الطمأنينة في تخفيف معنى الإهانة.
سيرة الناقد الفلسطيني تشتبك مع سير آخرين، أمثال إحسان عباس "غربة الراعي"، وجبرا إبراهيم جبرا "صيّادون في شارع ضيّق"، وسرديات لغسان كنفاني وسميرة عزّام وحسين البرغوثي. سير كُتبت بحبر الحنين في المقام الأول، لافتاً إلى أنّ اللاجئ يكتب سيرة ذاتية منقوصة تتعلّق بماضيه المستمرّ لا مستقبله. سيرة المخيّم والحصار والشهداء والمنفى. هكذا تنهال الصور من الذاكرة، ذاكرة طفل الخامسة وهو يغادر قريته الفلسطينية "الجاعونة" إلى قرية "جويزة" السورية كأول اختبار لصدمة النكبة ومعنى الاقتلاع والإقامة المؤقتة وعنف الغربة. يعتمد هذا الناقد الفلسطيني التنويري في توثيق سيرته نبرة روائية بجرعات متفاوتة في الإيقاع السردي كأنما يضمر نصّاً روائياً ملتبساً يتأرجح بين الوقائع التي خبرها عن كثب والتخييل الذاتي في تأطير معنى المنفى صعوداً من المكان الأول نحو أمكنة مؤقتة تنطوي على اغتراب وجودي كنهج عنيف في الحياة. في رحلة الشاحنة نحو الشمال وتوقّفها أمام استراحة على الطريق، ستلفت انتباه الطفل صورتان، سيعرف لاحقاً أنّ الأولى للمجاهد الفلسطيني عبد القادر الحسيني، والثانية للزعيم السوفياتي جوزف ستالين. ستُطبع بذاكرته صورة المجاهد الأول كرمز لا يُمحى في التاريخ الفلسطيني المغدور كمحصّلة لهزائم لاحقة، وما على الغرباء إلّا أن يسردوا أحزانهم.
إقرأ أيضاً: جبرا إبراهيم جبرا: جوهر الحياة الفلسطينية يقوم على محو آثار النكبة
يروي فيصل درّاج رحلة الصعود إلى المنفى الأول نحو قرية الجويزة من ريف القنيطرة في سوريا، وينتمي الصعود هنا إلى كلّ من الجغرافيا والثيولوجيا، وفي كليهما مشقّة، وسيرى الطفل في رحلة الصعود التعدّد الإثني: العرب، والشركس، والتركمان متجذّرين في مكان هو وحده دخيل عليه، على رغم كونه عربياً، وكان التمييز يبدأ في حجرة الدرس برفع اليد بالنسبة إلى اللاجئين، ليتعرّف الطفل شيئاً فشيئاً إلى اختلافه في استعارات يؤكّد فيها أنّ جسده مثل بقيّة الأجساد، لكنّ الاختلاف سيظلّ قائماً.
المنعطف الحاسم في هذه السيرة سيتجلّى في مدينة دمشق. هناك حيث درس الفلسفة في جامعتها، منخرطاً بقراءة ألبير كامو ونجيب محفوظ وغسان كنفاني، ذلك أنّ "الغريب لا تاريخ له". أما الصدمة الكبرى التي ستواجهه فستحدث في مطار باريس التي قدم إليها كطالب دكتوراه في جامعة السوربون. سيجيبه ضابط أمن المطار وهو يتأمّل جواز سفره "إنني آسف فلا وجود على خريطة العالم لبلد له اسم بلدك"! ورقابة شديدة الحراسة.
سوف يدرك أثناء رحلة المنفى المتشعّبة ثلاث صور عملية للغريب: غربة الصبي، والطرد المحتمل، وفي طور الشيخوخة: رقابة شديدة الحراسة.
هكذا عاش أجواء باريس ما بعد ثورة الطلبة 1968 كواقع ملموس وليس كأسطورة متعدّدة الوجوه قبل الوصول إليها فعلياً، مسترشداً بأسماء رفاعة الطهطاوي، وجمال الدين الأفغاني، وأندريه بلزاك، وطه حسين، وجان بول سارتر، وآخرين، قبل أن ينخرط بمناخات الطلبة الفلسطينيين ومناصريهم مثل جان جينيه الذي زار المخيمات الفلسطينية في الأردن وعاين عن كثب أحلام الفدائيّين ومكابدات اللاجئين في مخيم صبرا التي سيدوّنها في كتابه "أسير عاشق" كشهادة عن قضية عادلة.
في بيروت التي عاد إليها في عام 1974 كمنفى اختياري، سيشقّ طريقه أولاً نحو مجلة "الطريق" كباحث غير متفرّغ قبل أن يختلط بعشرات المثقّفين العرب. سيتعرّف أولاً إلى الروائي الأردني غالب هلسا الذي جرى ترحيله من القاهرة إلى بغداد ثم إلى بيروت، وسيلتقي العراقي غائب طعمة فرمان صاحب رواية "النخلة والجيران"، وكذلك المسرحي السوري سعد الله ونوس، والجزائري الطاهر وطار، والروائي السوري حيدر حيدر. هذه الورشة من المبدعين العرب الذين وجدوا في بيروت في السبعينيات، وعلى نحو أدقّ "إمبراطورية الفاكهاني" ملاذاً آمناً لأفكارهم وتطلّعاتهم خارج بلدانهم أتاحت لصاحب "الرواية وتأويل التاريخ" أن يتلمّس طريقه الخاصّ، من دون بهرجة أو ادّعاء، وذلك بتأصيل حقل نقدي مشغول بتطريز يحمل بصمة صاحبه. ستكبر دائرة معارفه تبعاً لمنظومته الفكرية، إذ التحق بالقائمة جبرا إبراهيم جبرا، ومعين بسيسو وإحسان عباس ومهدي عامل.
إقرأ أيضاً: غسان كنفاني يقترح الحل لتحرير فلسطين
من صخب بيروت ومباهجها المعرفية سنرتطم فجأة بمذابح مخيم تل الزعتر وكيف جرى إعدامه علناً، في حكايات عن الموت وتناسل الضحايا، وتعطيل الحواس في انتظار الفرج، إلّا أنّ سقوط المخيم لم يغلق الحكاية، فالأحزان "تشبه بثوراً حمراء تنتشر حارقة فوق سطح الجلد وتتحوّل، إن طالت إلى بقع سوداء، لا تزول، تستقرّ وتنغرس في الذاكرة التي من دونها لا يوجد تاريخ". ومثلما كان "الصعود إلى دمشق" عتبةً أولى للنزوح، ها هو يغلق الدائرة نزولاً إلى دمشق بعد ترحالٍ طويل، ليس بوصفها "إقامة مؤقتة"، أو "حالة قلق وغفلة وانتظار وشجن"، بل كمدينة أليفة متعدّدة الطبقات ومتوالية من الأزقة والحارات المظلمة، وصولاً إلى ساحة السبع بحرات ومقام الشيخ محيي الدين بن عربي. يقول بنوع من الحنين "مدينة رسمت على جدران حياتي خطوطاً تشبه صوراً على جدران كهف قديم".
محطة فاصلة أخرى عن لقاء الأرواح، جمعته بالروائي عبد الرحمن منيف، وسعد الله ونوس، حيث أسسوا معاً مشروعاً تنويرياً حمل اسم "قضايا وشهادات"، وهو محاولة جدّية لإحياء أسئلة النهضويين العرب. استمرّ المشروع نحو أربع سنوات ثمّ انطفأ بغياب الصديقين. "صوّر الكتاب الذي لم يعش طويلاً، أبعاداً من جماليات الصداقة وإخلاص الأحياء للأموات وتكامل الثقافة الإنسانية، التي تعترف بوحدة العقل الإنساني". وكما في كلّ سيرة من هذا الطراز تحضر قبور الموتى وأسماء الشهداء ودلالة الملصق الفلسطيني كتأريخ موازٍ لتحوّلات البلاد المحتلّة. أما علاقته بمحمود درويش فقد مرّت بمطبّات وسجالات مختلفة، لكنه سيقشّر الأوهام التي علقت بشخصية الشاعر الفلسطيني لجهة الغرور والغطرسة. "كان يواجه ويبتعد عن اليأس، ويقترب من الموت ولا يطلب المواساة إلى أن انتزعه الموت من بين قصائده ووضعه في قبر يطلّ على الكرمل". عدا صداقته مع محمود درويش، سيطلّ على شخصيات فلسطينية أخرى مثل ناجي العلي وعز الدين المناصرة وإحسان عباس إلى صداقات أخرى مع المخرج المصري توفيق صالح، والروائي جمال الغيطاني، والروائي الأردني الياس فركوح، فيما يخصّص الفصل الأخير من سيرته لمراياه الذاتية التي امتزجت تدريجياً بالنكبات الفلسطينية المتلاحقة.















