كتاب جديد يشرح "الضغط من أجل الصهيونية على جانبي الأطلسي"
يكشف كتاب"الضغط من أجل الصهيونية على جانبي الأطلسي" عن مدى تعقيد العلاقة بين "إسرائيل" والنخب السياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا، وكيف أن سعيها المستمر لإثبات شرعيتها يعكس تناقضاً جوهرياً في مشروعها الاستيطاني.
-
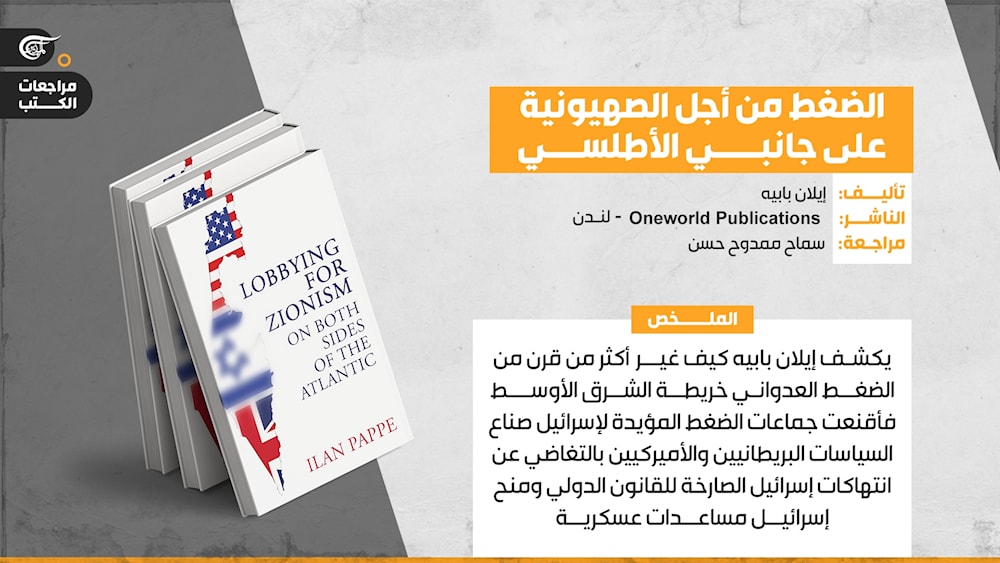
"إسرائيل" والغرب: تحالف استراتيجي أم خضوع سياسي؟
في كتابه الأخير"الضغط من أجل الصهيونية على جانبي الأطلسي" يقدم المؤرخ "إيلان بابيه" دراسة معمقة حول التأثير الكبير والفعّال الذي مارسه اللوبي الإسرائيلي على السياسة الدولية، وخصوصاً في الولايات المتحدة وبريطانيا، عبر التاريخ. يبدأ بابيه الكتاب بتناول فرضياته وأطروحاته التي تركز على محاولة فهم دافع "إسرائيل" المستمر لطلب الاعتراف بشرعيتها. يشير بابيه إلى أن هذا الطلب المتواصل يعكس، من وجهة نظره، شعوراً ضمنياً بعدم شرعية المشروع الصهيوني، وهو ما يدفعه إلى البحث عن قبول دولي دؤوب، بينما يتجاهل القضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين.
من خلال تحليل مفصل لتاريخ الضغط السياسي واللوبي الإسرائيلي في المحافل الدولية، يعرض بابيه محطات تاريخية هامة، بدءاً من تأثير المسيحيين الإنجيليين في بريطانيا والولايات المتحدة على دعم الحركة الصهيونية، وصولاً إلى دور اللوبي الإسرائيلي في تشكيل السياسات الأميركية والبريطانية حتى الآن.
لكن، عند الحديث عن اللوبي الإسرائيلي، من الضروري التمييز بين النفوذ السياسي الواسع للحركة الصهيونية في الغرب وبين المنظمات الداعمة التي تلعب دوراً أساسياً في هذا التأثير، مثل "اللجنة الأميركية- الإسرائيلية للعلاقات العامة" (أيباك). فاللوبي الإسرائيلي لا يقتصر على منظمة واحدة، بل هو شبكة مترابطة من الكيانات السياسية، والاقتصادية، والإعلامية، والمؤسسات البحثية، التي تعمل معاً للتأثير على القرارات الاستراتيجية في الولايات المتحدة وبريطانيا.
يختلف اللوبي السياسي الإسرائيلي عن المنظمات الداعمة في أنه يمثل نهجاً أوسع يهدف إلى ضمان التفوق الإسرائيلي على المستوى الدولي، من خلال التأثير على مراكز صنع القرار، وتوجيه السياسات الخارجية، والدفاع عن مصالح "إسرائيل" في المحافل الدبلوماسية. أما المنظمات الداعمة، مثل "أيباك"، فهي أدوات تنفيذية تعمل ضمن هذا الإطار، وتركز على استمالة المسؤولين الأميركيين، وتوجيه الرأي العام، وتمويل الحملات السياسية لضمان دعم غير مشروط لـ"إسرائيل".
ورغم النفوذ الكبير لـ"أيباك"، فإنها ليست اللاعب الوحيد، إذ توجد منظمات أخرى، مثل "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" و"التحالف المسيحي من أجل إسرائيل"، التي تساهم في تشكيل الرأي العام وتوسيع شبكة النفوذ الإسرائيلي في الغرب.
وليكشف بابيه للقارئ سبب إصرار الحركة الصهيونية و"إسرائيل" بشدة على تأكيد شرعيتها في الغرب، يبدأ في شرح الموضوع من خلال حادثة شخصية مر بها في جامعة إكستر، حيث انعقد مؤتمر"الاستعمار الاستيطاني في فلسطين" الذي واجه ضغوطاً شديدة من اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل"، لدرجة توجيه الاتهام إلى المؤتمر بمعاداة السامية، رغم أنه كان مجرد مساحة لنقاش أكاديمي. ويشير بابيه إلى أن الحملة ضد هذا المؤتمر كانت تهدف إلى تقييد الحوار حول القضية الفلسطينية، إذ طالبت بعض الأصوات بتغيير المصطلحات مثل "أرض الميعاد" بدل"فلسطين". وقد تجسد هذا التضييق على أكاديميين لدرجة طردهم من وظائفهم، فضلاً عن منع أي فعاليات أكاديمية تتعلق بفلسطين، وهو ما يعكس محاولة لإلغاء النقاش حول القضية بشكل شامل.
منذ زمن لم يعد اللوبي الإسرائيلى فى الغرب مهتماً بكسب شرعية احتلاله، لدى العامة، بل يركز على كسب هذه الشرعية في أوساط النخب في بريطانيا وأميركا قوتَي الأطلسي، وهذا هو اللغز، لماذا تعتقد النخب الإسرائيلية أن شرعيتها لا تزال موضع نقاش في بريطانيا والولايات المتحدة على الرغم من صفقات الأسلحة، والمساعدات الاقتصادية، والدعم الدبلوماسي غير المشروط؟ ولحل هذا اللغز وضع المؤرخ، نظرية وثلاث فرضيات، هي كالآتي:
بالنسبة إلى النظرية فإنه يقول إن السر، كما يعتقد، وراء إصرار "إسرائيل" على كسب الشرعية يكمن في الوعي البشري، حيث يدرك قادة الصهيونية، منذ نشأتها وحتى اليوم، الظلم الكامن في مشروعهم، حتى لو لم يعترفوا به صراحة. فهم، سواء بوعي أو بلا وعي، يدركون أن العالم ينظر إلى الصهيونية كمشروع استعماري قمعي. لا توجد وثائق رسمية تثبت هذه الدوافع الداخلية حتى الآن، لكن التحليل التاريخي لطريقة عمل اللوبي الإسرائيلي منذ تأسيسه يكشف هذا التوتر الأخلاقي. فـ"إسرائيل"، رغم نجاحها في فرض واقع سياسي وعسكري قوي، لا تزال تشعر بالحاجة المستمرة لإثبات شرعيتها أمام العالم، ما يفسر استثمارها الهائل في الضغط السياسي والدبلوماسي. ورغم عدم مقدرته على إثبات هذه النظرية، فإنه يقول إن باستطاعته إثبات الفرضيات الثلاث التي تفسر اللغز، وهي:
الفرضية الأولى، تقول إنه لطالما سعت الحركة الصهيونية إلى ترسيخ فكرة تفردها الأخلاقي، بل وحتى تفوقها، من خلال الترويج لرواية مختلفة عن طبيعة مشروعها في فلسطين. كان هذا الهوس نابعاً من حاجة قادتها، ومن بعدهم "الدولة" الإسرائيلية، إلى إقناع أنفسهم والعالم بأن الصهيونية ليست مجرد حركة استعمارية، بل حالة استثنائية لا تشبه غيرها من المشاريع الاستيطانية. لقد أرادوا تصديق أن ما قاموا به كان مسعى نبيلًا، حتى لو أدرك بعضهم في قرارة نفسه التناقضات الأخلاقية التي تحيط بهذا المشروع.
أما الفرضية الثانية فتوضح أنه منذ وقت مبكر، ومع تزايد شكوكها الذاتية، تخلت الصهيونية عن تبرير مشروعها أخلاقياً وتجنبت الانخراط في نقاشات واسعة مع المجتمعات. وبدلاً من ذلك، ركزت جهودها بالكامل على استمالة النخب، مستفيدة من الموارد المالية، والعلاقات السياسية، والاستراتيجيات الدعائية الفعالة. وعندما تبنت "إسرائيل" هذا النهج، أصبح نفوذها السياسي أكثر قوة وتأثيراً، ما منحها تفوقاً واضحاً على غيرها من جماعات الضغط في بريطانيا والولايات المتحدة.
ويصل بالشرح إلى الفرضية الثالثة والقائلة بأن النفوذ السياسي الذي سعت الصهيونية إلى ترسيخه داخل النخب، أدى إلى نشوء لوبيات قوية على جانبي الأطلسي، أميركا وبريطانيا، تحولت إلى كيانات مستقلة ذات مصالح خاصة، وأحياناً كان دافعها الأساسي الحفاظ على نفوذها أكثر من دعم "إسرائيل" نفسها. ورغم وجود عوامل أخرى، ساعدت "إسرائيل"، كالمجمعات العسكرية - الصناعية والشركات متعددة الجنسيات، فإن اللوبيات المسيحية واليهودية ظلت الأكثر تأثيراً في تعزيز شرعيتها. ومن المفارقات أن "إسرائيل"، رغم مكانتها الراسخة، لا تزال تعتمد على هذه اللوبيات لكسب الاعتراف والدعم، وكأن شرعيتها لا تزال محل جدل حتى في القرن الحادي والعشرين.
تعدّ المسيحية الصهيونية من أهم موضوعات الكتاب، حيث يتناول جذور المسيحيين الإنجيليين ودورهم في بريطانيا والولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر. ويعرض كيف أن الشخصيات البريطانية الأشهر كبلفور ولويد جورج وبلير وبراون، وكذلك الرئيس الأميركي ترومان، وبيل كلنتون، وجميعهم نشأوا في بيئات إنجيلية، هم من دعم الصهيونية واللوبي الإسرائيلي بقوة.
ثم يستعرض دور النخب البريطانية في تشكيل المشروع الصهيوني، حيث تناقش فصول الكتاب الضغوط السياسية التي أدت إلى صدور وعد بلفور واستمرت خلال فترة الانتداب. ومع انسحاب بريطانيا من فلسطين عام 1947، تحول التركيز إلى الولايات المتحدة، الإمبراطورية الجديدة، فيوضح نشأة النفوذ الصهيوني في السياسة الأميركية ودوره خلال الهولوكوست. وبعدها، يستغرق في رصد تصاعد نفوذ اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة منذ عام 1947 وحتى اليوم. أخيراً، يعود إلى بريطانيا لاستكشاف دور اللوبي الإسرائيلي في القرن الحادي والعشرين، وحتى تداعيات السابع من أكتوبر.
يشير بابيه إلى أن اللوبي الإسرائيلي في أميركا لا يستطيع دائماً فرض سياساته، ويستشهد بإصرار أوباما على توقيع الاتفاق النووي الإيراني، ومحاولات بايدن لإحيائه، رغم معارضة منظمة"أيباك" الشديدة. ومع ذلك، يلاحظ أن الرؤساء الأميركيين يميلون إلى معارضة اللوبي في قضايا الشرق الأوسط الأوسع، لكنهم غالباً ما يرضخون عندما يتعلق الأمر بفلسطين، كاتفاقات أوسلو، التي رغم أنها لصالح "إسرائيل"، فإنها واجهت معارضة من "أيباك"، ما يعكس فرضية بابيه بأن بعض المنظمات الصهيونية تعمل أحياناً للحفاظ على نفوذها أكثر من خدمة المصالح الإسرائيلية الحقيقية.
يعقد بابيه مقارنة بين الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والأميركي والأسترالي. ويقول إن الدول الاستيطانية كالولايات المتحدة وأستراليا تمكنت من فرض سيادتها من دون الحاجة المستمرة إلى تبرير شرعيتها، لأن السكان الأصليين في تلك الدول تعرضوا لإبادة واسعة النطاق جعلتهم غير قادرين على تشكيل تهديد حقيقي لاحقاً. في المقابل، "إسرائيل" لم تستطع القضاء على الفلسطينيين، فوجودهم المستمر ومقاومتهم السياسية والثقافية والعسكرية يجعلها في حالة قلق دائم من فقدان شرعيتها، ما يفسر استثمارها الهائل في حملات الضغط والدعاية لضمان استمرار الاعتراف بها عالمياً.
يكشف كتاب"الضغط من أجل الصهيونية على جانبي الأطلسي" عن مدى تعقيد العلاقة بين "إسرائيل" والنخب السياسية في الولايات المتحدة وبريطانيا، وكيف أن سعيها المستمر لإثبات شرعيتها يعكس تناقضاً جوهرياً في مشروعها الاستيطاني. ورغم نجاح اللوبي الإسرائيلي في تشكيل السياسات الدولية لصالح "إسرائيل" لعقود، فإن المشهد العالمي يشهد تغيرات قد تعيد رسم خريطة التأثير السياسي.
فمع تصاعد الخطاب المناهض للاستعمار الاستيطاني، وازدياد الوعي العام بالقضية الفلسطينية، يواجه اللوبي تحديات متزايدة، خصوصاً مع تراجع شعبية الدعم غير المشروط لـ"إسرائيل" بين الأوساط الشبابية والأكاديمية في الغرب. إضافةً إلى ذلك، فإن انقسامات الداخل الإسرائيلي، وتصاعد الانتقادات من شخصيات يهودية مؤثرة ككاتب هذا العمل، قد تضعف قبضة اللوبي على مراكز صنع القرار.
وهنا، يبرز التساؤل: هل سيظل النفوذ الإسرائيلي قادراً على فرض إرادته في المستقبل بالقوة نفسها، أم أن التغيرات السياسية والاجتماعية ستؤدي إلى تراجع تأثيره تدريجياً، ما يفتح المجال لمقاربات أكثر عدالة تجاه القضية الفلسطينية؟












