"دير ياسين": شهادةٌ على دموية "إسرائيل"
إنَّ فكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ما هي سوى التباس فضفاض لوصف مفردة وطن، وما اختراع المظلوميات اليهودية المتمثلة بالنفي المغروس في الشخصية اليهودية إلا أدوات لتأسيس ذلك الوجود المخادع.
-
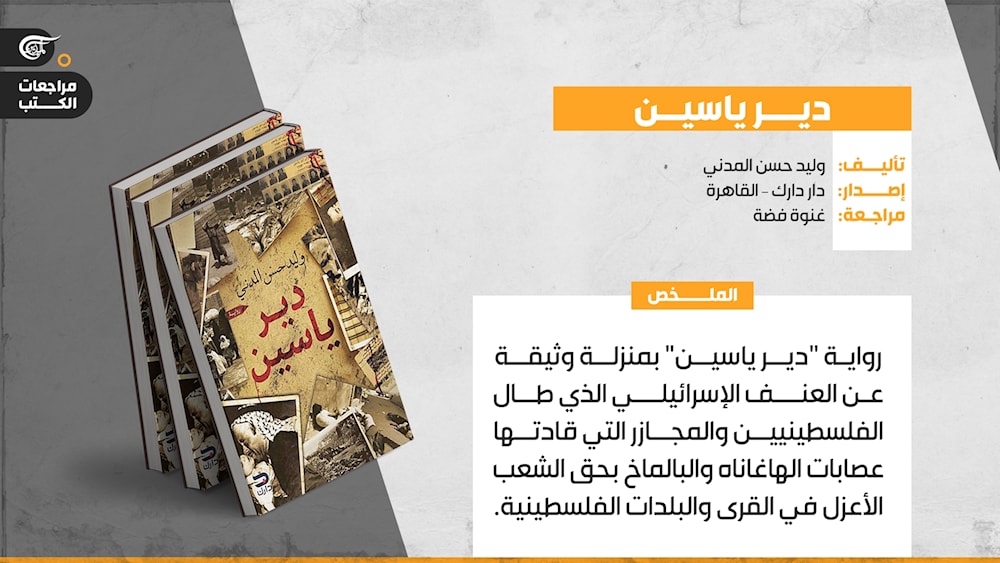
رواية "دير ياسين": شهادةٌ على دموية "إسرائيل"
في ظل مواصلة المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية إخفاء الوثائق التي تثبت جرائم الكيان بحق الشعب الفلسطيني، تحضر الرواية كفَنّ ينتصر للأصوات المكتومة، ويسمح لأصحاب الحق والأرض بالدفاع عن وجودهم.
ولعلها وظيفة الفن والأدب في الوقوف إلى جانب الإنسان، ومنحه الفرصة التي تسمح لصوته بالظهور، ولتلك الصرخة المكتومة بأن تصدح في عالم اليوم. من هنا تحضر رواية "دير ياسين" للكاتب المصري وليد حسن المدني، الصادرة عن دار دارك في القاهرة، بمنزلة وثيقة تؤرشف العنف الإسرائيلي الذي طال الفلسطينيين والمجازر التي قادتها عصابات الهاغاناه والبالماخ بحق الشعب الأعزل في القرى والبلدات الفلسطينية.
تبدأ الحكاية من اللدّ، ومع أسرة وداد وطفليها عايدة وياسين المنكوبين بموت الأب على خلفية حادث سيارة مجهول. هنا، تلجأ الأسرة إلى قرية دير ياسين، وتلتمسُ المأوى من صديقٍ تطالعهم وفاته فور وصولهم؛ تلك المصادفة التي تقود إبراهيم إلى تقديم المساعدة لأصدقاء أخيه الراحل، الأمر الذي يؤسس لوجود وداد في القرية، ويؤمن للحبكة الروائية لاحقاً النمو ومعرفة ما جرى في دير ياسين آنذاك.
نطالع أهالي القرية بعاداتهم وأفراحهم وأتراحهم، وأصحاب الأموال فيها وعلاقتهم بالمندوب البريطاني ودوره الذي أدّاه لزرع الثقة بوعود الصهاينة، إلا أن الراوي الفريد من نوعه هنا، وهو شجرة زيتون معمرة وضعها الكاتب على مدخل القرية، وجعلها بمنزلة شاهد على الأحداث التي جرت في الماضي وما سيجري لاحقاً، ترصد لنا تسلسل الأحوال والتطورات الاجتماعية والاقتصادية في مجتمع القرية الصغير، والتي أدت إلى إبادتها وتحويلها إلى مستوطنة إسرائيلية.
هنا قريةٌ توضع على حافة الإرهاب، ويصور الكاتب بعد لجوء وداد إليها الدور الذي أداه البريطانيون في خداع سكانها الفلسطينيين والضغط عليهم، وإغرائهم كذلك الأمر في الانصياع لقراراتهم. ذلك الدور تؤديه جانيت زوجة إبراهيم ببراعة، إذ تمكنت عبر المكايد، ومن خلال علاقتها بالضابط ديفيد، من التغلغل إلى داخل الأسَر في القرية، وزرعت الشقاق بينهم، ونصبت الفخاخ لزوجها ولزعامة القرية متمثلة بسليم أبي زيد لعقد الصلح مع البريطانيين والامتناع عن التعرض لليهود الوافدين إلى محيط القرية.
لا تأتي الأحداث هنا بشكل مباشر، بل من خلال تصوير الحياة في قرية دير ياسين التي نجدها واقعة تحت تأثير التوجس والحذر من تصاعد الأحداث حولها. وهنا تسير الرواية في خطين سرديين: الأول؛ تصاعدي يبني الحدث السياسي ويهيئ أحوال الإبادة، والآخر اجتماعي يرصد آثار الفتنة البريطانية بين أهالي القرية عبر التوغل في أعمال إبراهيم وسليم أبي زيد، إذ يكبر ياسين وعايدة، ويصيران جزءاً من نسيج القرية، وتنمو صداقة بين ياسين وإسماعيل تشكل مع الوقت بؤرة لخلية مقاومة صغيرة في القرية، إلا أن خطاً آخر ينحو بالقصة إلى سياق عنوانه الحب المحرم، إذ يقع ياسين في حب إيلان اليهودية؛ تلك العلاقة التي تتطور في الخفاء، وتحمل من الصدق ما يجعلها تثمر طفلاً يمسي ضالة العصابات اليهودية.
ما يحدث هنا ليس مجرد مجموعة عصابات تقتحم قرية، بل هي عملية اقتلاع جذري نُفذت ضد قرية عزلاء، وحدثت بطريقة تأنف الوحوش عن ارتكابها، ذلك أن الدخلاء يحضرون في جميع مفاصل الرواية، من بن تيسون وقيادة الهاغاناه ومجرمي مناحيم بيغن، ومرتزقة يستبيح وجودهم الأرض والمصائر، وحتى المشاعر والتحكم في شؤون الحب ومنع إيلان من لقاء ياسين في محاولة لخطف الطفل ومنحه لليهود.
إذاً، هي عصابات توافدت إلى فلسطين من كل بقعة في الأرض، وجيوش من المرتزقة زُرعت حول محيط القرية، وأسست هناك معسكرات ظهرت في الرواية كعوامل أقلقت يوميات القرية وسببت الأرق لشبابها.
لذا، نجد أن الترهيب الذي قام به بن تيسون حين جمع نساء القرية في المسجد واختار عايدة ليُنفذ بها جريمة إنسانية أمام أعين الجميع هدفه قتلُ الجنين، وقتلُ كل بارقة أمل بالحياة لسكان القرية، إلى جانب زرع الرعب وترويع باقي القرى والتأسيس لإبادة سكانها الفلسطينيين.
تُدارُ الخطط من وراء الكواليس، وينمو كرهٌ خفيٌّ بين جانيت وأسرة وداد؛ ذلك الكره الذي يكشف بعد المجزرة أنها من قاد السيارة لدهس زوج وداد ورفيقه، وأنها الخائن الذي راقب أهالي دير ياسين وهم يتزودون بالسلاح.
تحضر هنا شجرة الزيتون كما لو أنها عدسة ترصد تكدس تلالٍ من الشهداء، وحربةٌ تذكر برفات أمة أماتتها الهزيمة، فالمجزرة حدثت، ولم تحدث بصورة عملية تطهير لجماعة عاشت في حيزها الجغرافي فقط، بل يريد الكاتب عبر وصفه تفاصيل المقتلة الاعترافَ بقصور الكلمات عن تفصيل ما حدث.
ذلك الترويعُ وتلك الإبادةُ وقتلُ كل ملمحٍ فلسطيني في القرية يشير إلى ثقافة تنتمي إلى منظومة العنف، وهو العنف ذاته الذي يمارسه بن تيسون على إيلان وياسين، والعنف نفسه الذي يؤسس الكيان عليه وجوده.
لذا، إنَّ فكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ما هي سوى التباس فضفاض لوصف مفردة وطن، وما اختراع المظلوميات اليهودية المتمثلة بالنفي المغروس في الشخصية اليهودية إلا أدوات لتأسيس ذلك الوجود المخادع، في وقت تأتي فيه الرواية في ظل الحاجة لتفكيك الماضي وإعادة بنائه تفنيداً لأكاذيب اليوم، وإيضاحاً لجرائم الأمس.
"على أي حالٍ، يجب أن تستمر المقاومة". هكذا يقنع إسماعيل صديقه ياسين بأن المقاومة هي سبيلهم الوحيد لإعادة حقهم في الحياة. بعد دهم المنازل، ولجوء ما بقي من عائلات دير ياسين إليها، لا يبقى لديهم منفذ سوى الشهادة، الأمر الذي لا يجعل الرواية مجرد نقل كلمات عن المجزرة، بل تصبح عملية تصوير حقيقي للطبيعة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، والتي سرعان ما تنقلب إلى داخل صفوفه حين جرى الشقاق بين الهاغاناه والبالماخ، مثلما تجسد ذلك النزاع في اغتراب إيلان عن جماعتها.
على الرغم من ذلك، يبقى زمن الرواية ثقيل الوطأة على القارئ، إذ لا عزاء فيما حدث أمام الواقع الذي صورته الحكاية، ولا فكاك من تلك الآلام التي أفرزها الظلم أمام فشل الأصوات الحرة في العالم عن إيصال صرخة الألم الفلسطيني، لتبقى في النهاية شجرة الزيتون رمزاً يؤجج الذاكرة، ربما كان رمزاً يعتريه الشعور بالهزيمة، بيد أنّه لا بدَّ من أن يستعاد لإبقاء القضية حية في النفوس، ووضع العالم أجمع أمام مسؤولية تعاميه عن المجازر بحق الفلسطينيين حتى اللحظة.














